
بنشاب : ليس التاريخُ رفًّا للغبار، ولا سجلًّا محايدًا للأحداث، بل كائنٌ حيٌّ لا يسلّم مفاتيحه إلا لمن امتلك جرأةَ الفعل، ووعى اللحظة، واستعدادَ الوقوف وحيدًا في مفترق الرياح. وفي مدارج الزمان، قلّ أن يتجسّد رجلٌ في طورٍ كاملٍ من أطوار الدولة، حتى يُصبح اسمه قرينَ مرحلة، وفعله ميزانَ قراءةٍ لما قبلها وما بعدها. هناك، في تخوم الذاكرة الوطنية، ينهض اسمُ محمد ولد عبد العزيز لا بوصفه صفحةً عابرة، بل باعتباره بناءً كثيفَ المعنى، عصيًّا على الاختزال، متشابك الجذور، متعدد الظلال، لا يُقرأ إلا بآلةٍ لغويةٍ دقيقة، ولا يُدرك إلا بعينٍ خبرت طبائع السلطة وأثقالها.
وُلد الرجلُ في زمنٍ كانت الدولة فيه تتلمّس ملامحها على مرايا هشّة، تتقاذفها الريبة، وتستنزفها الترتيبات المؤقتة. فجاء حضوره على هيئة قَطْعٍ مع التردّد، لا على طريقة الضجيج، بل بمنطق الحسم الذي لا يعتذر عن نفسه. لم يكن ظهوره ارتجالًا، ولا اندفاعًا بلا حساب، بل تراكمَ تجربةٍ عسكريةٍ صلبة، صقلت فيه معنى الانضباط، ودرّبته على قراءة الخرائط لا بوصفها خطوطًا، بل بوصفها احتمالاتٍ للنجاة أو السقوط.
في عهده، لم تكن السلطة متكأً للترف، بل عبئًا يُحمل على الكتف كما تُحمل الأمانات الثقيلة. تَقدّم إلى مركز القرار بوعيٍ حادّ بأن الدولة، إن لم تُستعاد هيبتُها، ستتآكل من الداخل، وأن السيادة، إن لم تُحمَ، ستُستبدل بوظائف شكلية تُدار من وراء الستار. فكان الاشتباك مع أخطر الملفات اشتباكًا مباشرًا، لا مواربة فيه ولا تزويق. واجه تهديدات الإرهاب بمنطق الوقاية الاستباقية، لا انتظار الضربة، فأعاد رسم معادلة الأمن، وبدّل موقع البلاد من هامش القلق إلى دائرة المبادرة، حتى صار اسمها يُتداول في الإقليم بوصفها مثالًا للاستقرار الصعب، لا الهشّ.
اقتصاديًا، لم يركن إلى المسكّنات، بل فتح ملفاتٍ طالها الصدأ، وأعاد ترتيب الأولويات على قاعدة الاستقلال في القرار، لا الارتهان للمواسم. سعى إلى تنويع الموارد، وتحصين المال العام، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة وثرواتها، فصار النقاش حول العدالة التوزيعية نقاشًا واقعيًا لا خطابيًا، مهما اعترضته العثرات. ولم يكن ذلك بلا كلفة، إذ إن من يُحرّك المياه الراكدة لا بد أن يوقظ المستفيدين من سكونها.
سياسيًا، كان حضوره مُربكًا للثنائيات السهلة. لم يُرضِ الجميع، ولم يسعَ إلى ذلك أصلًا. اختار أن يكون مركز ثقلٍ لا ظلًّا تابعًا، وأن يدير التوازنات لا أن يخضع لها. فبنى شبكة علاقاتٍ خارجيةٍ تقوم على الندية، لا على الاستجداء، وعلى المصالح المتبادلة، لا على التوقيعات المجانية. وفي الداخل، أعاد تعريف مفهوم الدولة القوية: دولة القانون حينًا، ودولة القرار حينًا آخر، بلا انفصامٍ بين النصّ والفعل.
أما اجتماعيًا، فقد تحرّك في فضاءٍ بالغ التعقيد، مثقلٍ بإرثٍ تاريخيٍّ طويل. لم يدّعِ امتلاك عصا المعجزات، لكنه طرق أبواب الإصلاح من زوايا متعدّدة، محاولًا تفكيك البنى العتيقة التي عطّلت الاندماج الوطني. وكانت خطواته، مهما اختلف حولها المتجادلون، إشاراتٍ على أن السكون ليس قدرًا، وأن إعادة هندسة المجتمع تبدأ من الاعتراف بمشكلاته، لا من إنكارها.
ثم جاءت المحنة، لتكون ميزانًا آخر للقراءة. ففي الشدائد، تتعرّى المواقف، وتنكشف المعادن. هناك، حيث يتراجع كثيرون إلى الظلال، بقي اسمه حاضرًا في السجال العام، لا بوصفه ذكرى منتهية، بل كقضية مفتوحة على التأويل. تحوّلت تجربته إلى مرآةٍ يرى فيها كلُّ طرفٍ انعكاسَ رؤيته للدولة والعدالة والسلطة. فصار الجدل حوله جدلًا حول معنى الحكم نفسه: أهو فعلُ بناءٍ يتحمّل صاحبه تبعاته، أم لعبةُ مواقعٍ بلا ذاكرة؟
على مرّ الزمان، يتبيّن أن الأسماء التي تثير هذا القدر من الاختلاف لا تكون عابرة. إنما هي علاماتٌ كبرى، تُستعاد كلما احتاجت الأمة إلى مراجعة مسارها. ومحمد ولد عبد العزيز، في هذا السياق، ليس مجرد رئيسٍ سابق، بل عقدةُ أسئلةٍ كبرى: عن الأمن، والسيادة، والاستقلال، وحدود الجرأة في مواجهة المألوف.
هكذا، يقف محمد ولد عبد العزيز في سجلّ الزمن وقوفَ الجبال: لا تُختزل في صورةٍ واحدة، ولا تُقرأ من زاويةٍ ضيقة. هو تجربةٌ كثيفة، لها ما لها، وعليها ما عليها، لكنها، في المحصلة، تجربةٌ صنعت أثرًا لا يُمحى بسهولة. سيختلف الناس حوله ما اختلفت القراءات، غير أن التاريخ، حين يفرغ من ضجيج اللحظة، لا يحفظ إلا من ترك بصمةً عميقة. وتلك البصمة، مهما حاولت الرياح طمسها، تظل شاهدًا على رجلٍ عاش في قلب الدولة، وترك فيها أثرَ من عرف أن الزمان لا يرحم المترددين...
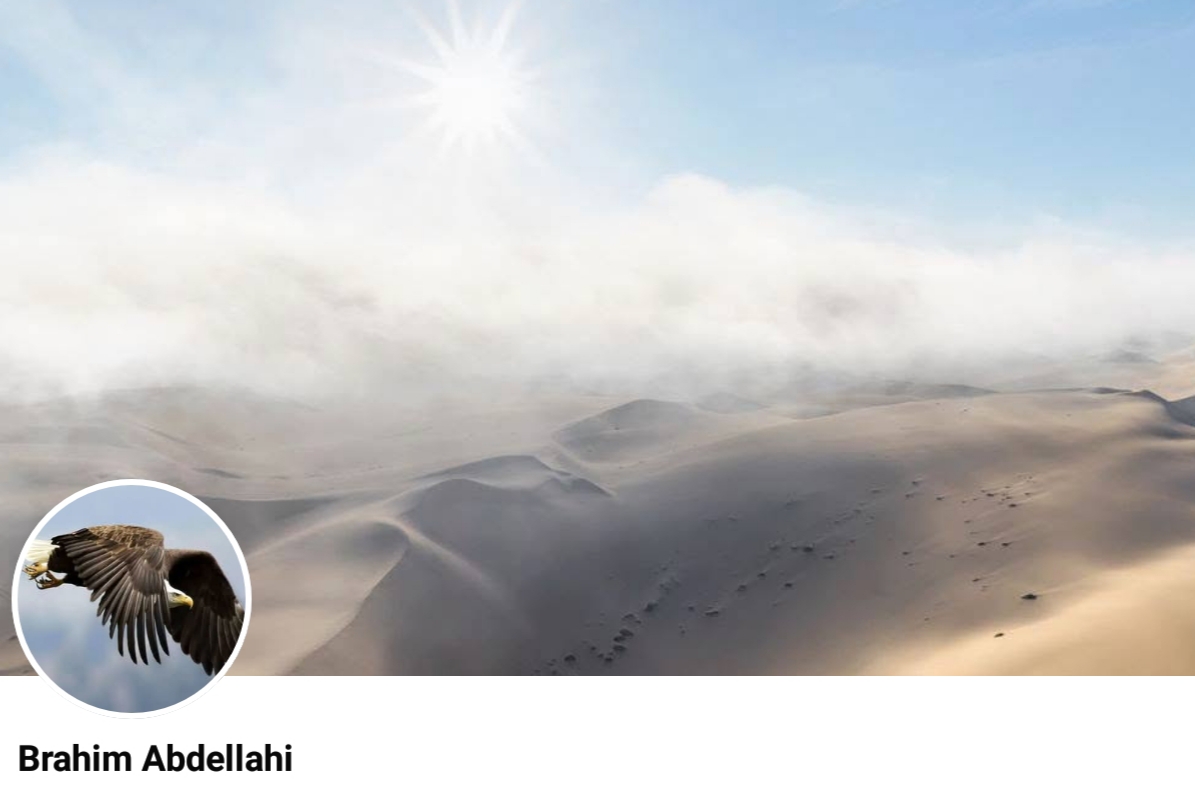



(2).JPG)





